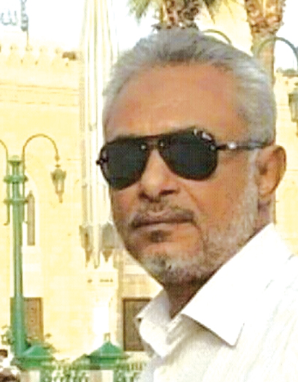
إن ما يميز نهاية شهر أكتوبر هو تراجع نسبي في الاستهلاك، لكن ذلك لا يعني أن المنظومة الكهربائية في حال أفضل. على العكس، فالتراجع يكشف واقعاً أكثر هشاشة. محطات التوليد الحكومية، مثل “ورسيلا (1) و ورسيلا (2) والحسوة الكهروحرارية، باتت في مراحل عمرية تحتاج إلى تقييم موضوعي، فنياً وإدارياً، مع وضع معالجات واقعية ذات جدوى اقتصادية.
خذ محطة الحسوة على سبيل المثال: أقدم وأكبر محطات التوليد في عدن. عادت مؤخراً إلى الخدمة بعد تزويدها بالمازوت، لكنها لم تنتج سوى 25 ميجا بالكاد، بعد أن كان مأمولاً أن تتجاوز 80/60 ميجا. مشكلتها لا تكمن فقط في تهالك معداتها واحتياجها لإعادة تأهيل فقط، بل أيضاً في عجز دائم عن توفير وقود مستقر. لذلك، يبدو تشغيلها أشبه بإنعاش مؤقت لا يمكن التعويل عليه في هذه الحالة.
أما محطة ورسيلا (1) والفرنسية خورمكسر، فقد تراجع إنتاجها الذي لا يتجاوز 5 ميجا فقط، وربما أقل، من أصل 20 ميجا، مع عمالة تفوق الحاجة. بينما محطة ورسيلا (2) في المنصورة، التي أنفٍقت عليها أموال تفوق قيمتها الفعلية، تراجعت من قدرة إنتاجية أساسية 10 ميجا للمولد الواحد إلى إنتاج طاقة إجمالية بـ 48 ميجا لستة مولدات، بواقع 8 ميجا للمولد الواحد. هذا التدهور يعكس حجم الترهل الفني والهدر المالي في آن واحد وتقادم منظومة التوليد.
المشهد لا يختلف كثيراً في المحطات الصغيرة: شيهناز، الملعب، حجيف، وانتر سولار. جميعها تعمل بوقود الديزل، بمولدات لا تتجاوز الواحد ميجا للوحدة، لكنها تكلف صيانة وقطع غيار تفوق ما تقدمه من إنتاج. وفي المحصلة، تتحول إلى عبء أكثر من كونها رافداً للطاقة.
في المقابل، هناك محطتان تبرزان كاستثناء: محطة الرئيس (عدن الجديدة) ومحطة الطاقة الشمسية. الأولى أثبتت استقراراً نسبياً في إنتاجها بتوربين واحد فقط، والثانية أظهرت أن الطاقة البديلة قادرة على أن تكون خياراً عملياً بتكلفة تشغيل منخفضة. وهذا ما يجعلها بارقة أمل لا بد من البناء عليها، خصوصاً أن المناخ في عدن يمنحنا ميزة طبيعية للاستثمار في الشمس والرياح.
لكن الواقع اليوم يقول إن التوليد الفعلي لا يغطي سوى 25 في المئة من الاحتياجات، أي ما يعادل نحو ست ساعات يومياً (في أفضل الظروف). وفي ظل شبكة مهترئة للنقل والتوزيع، يصبح أي توسع في التمديدات الجديدة أمراً غير منطقي، لأنه يضاعف الأعطال والضغط على منظومة عاجزة أصلاً.
من هنا، فإن جوهر الأزمة لم يعد مقتصراً على مسألة التوليد وحده، بل على إدارة القطاع كمنظومة متكاملة تشمل التوليد والنقل والتوزيع والصيانة والتمويل والموارد البشرية. ما لم تتحول الصيانة من إسعافية إلى وقائية، وما لم يُعد تقييم جميع المحطات لتحديد ما يستحق الاستمرار وما يجب استبداله أو إيقافه، وما لم تتم معالجة الترهل الوظيفي وتضخم العمالة، فإن أي حلول ستظل مؤقتة لا تصمد أمام أول اختبار في الصيف القادم.
إن التوسع في الطاقة الشمسية والرياح لم يعد ترفاً أو خياراً مؤجلاً، بل ضرورة وطنية لتقليل الاعتماد على الوقود المستورد والمكرر محليا. كما أن إعادة هيكلة إدارة القطاع على أسس من الشفافية والتخطيط طويل المدى، هي الطريق الوحيد لكسر الحلقة المفرغة من الأزمات.
الخلاصة.. إن أزمة الكهرباء في عدن لم تعد فنية فحسب، بل هي أزمة قرار وإرادة سياسية. إذا بقي النهج الحالي القائم على المسكنات، فإن المعاناة ستتكرر كل صيف مع تكاليف أكبر يدفعها المواطن والاقتصاد والخدمات. أما إذا تحولت إدارة الكهرباء إلى تخطيط واستدامة، فقد نجد أنفسنا أمام بداية جديدة تقطع دوران هذه الدوامة الطويلة.

