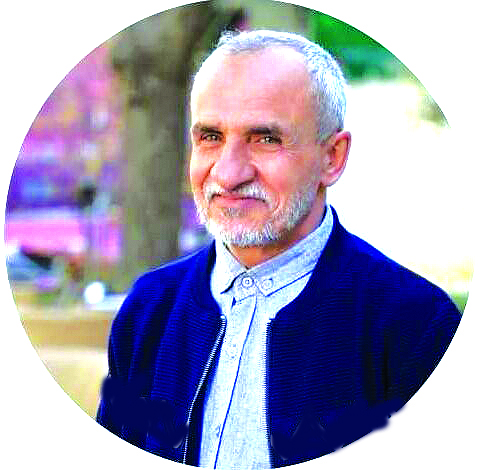
الطامة الكبرى أن الجهات المعنية لم تستفد من تجارب تحول الأمطار إلى كوارث محققة، فكل قنوات التصريف في المدن والأحياء مثلا كانت خارج الجاهزية. ومع أن الإرصاد الجوية وبيانات وتوقعات الطقس كانت تشير بوضوح إلى فترات هطول الأمطار، وأحيانا تتوقع بصورة أقرب للواقع منسوبها وإمكانية تدفق السيول، إلا أن الجهات المعنية لم تفعل مبكرا إجراءات الطوارئ قبل حلول موسم المطر، مثلها في ذلك مثل بقية حالات الطوارئ الأخرى، كلها لا تبدأ عملها إلا بعد حلول الكارثة.
من المتعارف عليه أن هيئات الطوارئ وفرق إدارات الأزمة هي هيئات عاملة وجاهزة للتعامل مع كل المتغيرات، ليس فقط في حالات الأزمات السياسية والاجتماعية، بل وفي حالات الطوارئ الطبيعية. وبعض الدول لديها وزارات تسمى وزارة الطوارئ تتحرك باستمرار، وتراقب وتحلل وتتخذ الإجراءات الوقائية الضرورية في وقت مبكر لمنع الأضرار أو للحد منها.
تسارع الجهات ذات العلاقة عادة إلى خلق المبررات التي أدت إلى تلك النتائج، بدلا من تحليلها والعمل على عدم تكرارها. لكن الكارثة تتكرر بنفس الكيفية، وتدور حلقة المبررات بنفس الكيفية أيضا.. هذا يحدث في كل مجال.. من إدارة الشأن السياسي إلى الرياضة والموارد البشرية والبيئية والطاقة... إلخ.
كل جهة تخلق لها غرماء يكونون سببا لإخفاقها. في حالتنا هذه يكون البناء العشوائي هو السبب الرئيسي والمواطن هو المذنب دائما، فهو الذي ينتهك القانون.
إذن، المواطن هو أساس كل بلية ورزية. لكن لماذا لم تتساءل هذه الجهات: لماذا يسلك المواطن (العامل، الموظف، العاطل، الفقير، العليل) هذا السلوك غير القانوني؟ ولماذا لم تبحث عن إجابة منطقية؟
في البدء، أخذت الدولة على عاتقها وحدها مهمة التصدي للمشكلة السكنية، ومنعت الناس من البناء تحت مختلف المبررات. وظلت المشكلة تتفاقم يوما بعد يوم حتى تحولت إلى معضلة لم تستطع الدولة فعل شيء حيالها، وكل ما استطاعت إنجازه من وحدات سكنية لم تبلغ 10 % من الاحتياج السنوي الفعلي، وحتى ذلك لم يتم توزيعه لتقليص حجم المشكلة بل وزع وفقا للأهواء والمحسوبية والمناطقية في أكثر الحالات، على الرغم من الادعاءات بعدالة الكمبيوتر.
طول الانتظار في قوائم السكن أحبطت الناس فاتجهوا بمبادرة شخصية كلّ لحل مشكلته وتخفيف العبء على الدولة. لكن ذلك لم يلق استحسان وزارة الإسكان ودائرة المهندس البلدي اللتين أصرتا على موقفهما من القضية رغم عجزهما البين.
قُدمت مقترحات لدائرة المهندس البلدي بضرورة التخلي عن فرض الرسوم المبالغ فيها، والاستجابة لمتطلبات المشكلة بتسهيل الإسكان الشعبي وتشجيع المواطنين على ذلك من خلال تقديم حوافز ملموسة، مثل: تخطيط المناطق التي هي عرضة بالفعل قبل غيرها لانتشار البناء العشوائي، أي المناطق المحيطة بالأحياء القائمة كالجبال مثلا في كريتر والمعلا والتواهي والبريقة. إلى جانب منح التراخيص والمخططات التفصيلية الملزمة برسوم رمزية. كانت هذه المناطق حينها شبه خالية من البناء العشوائي، وكان بالإمكان السيطرة عليه بسهولة من خلال النموذج الذي يتم بناؤه، ثم جاءت عقارات الدولة والتخطيط العمراني لتسير على نفس الخطى. هذه السياسات هي التي شجعت على انتشار البناء العشوائي والبسط الواسع على الأراضي، ليس فقط من قبل المحتاجين لحل مشاكلهم السكنية بل ومن قبل مختلف النافذين والمتنفذين.
كان من الممكن مجابهة المشكلة والتخلص منها في البداية. لكن أصبحت المسألة غير قابلة للحل الآن.
الحل ممكن، لكنه سيكون صعبا ومكلفا ويحتاج إلى خطوات شجاعة وإرادة للقيام بإجراءات صعبة ومؤلمة بكل تأكيد. هذا الحل سيتطلب أولا الاعتراف بالأخطاء في تقدير الأمور والنتائج، إلى جانب القيام بإعادة تخطيط كافة المناطق التي طالها العشوائي وإتاحتها أمام ساكنيها، إضافة إلى القيام بعمليات هدم جزئي أو كلي للبناء القائم، مع التكفل بتقديم تعويضات عادلة للمتضررين تمكنهم من إعادة بناء منازلهم وفقا للمخططات العامة. فهل نمتلك الشجاعة للقيام بذلك؟

