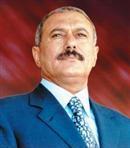ماذا يعني النظام الرئاسي الكامل في مبادرة الرئيس؟
د.علوي عبدالله طاهر:في المبادرة التي قدمها الاخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية لإجراء تعديلات دستورية تهدف إلى تطوير النظام السياسي الديمقراطي في بلادنا ورد فيها عدة نقاط تتعلق بإصلاح النظام السياسي في الحكم مفادها:- النظام السياسي للحكم يكون رئاسياً كاملاً:- مدة رئاسة الجمهورية خمس سنوات.- تتكون السلطة التشريعية من غرفتين : مجلس النواب، ومجلس الشورى.- انتخاب مجلس النواب كل أربع سنوات.- انتخاب مجلس الشورى كل أربع سنوات.(صحيفة الثورة 25/9/2007م).وهناك نقاط أخرى تتعلق بتطوير نظام الحكم المحلي لسنا في صدد تناولها في هذه المقالة لكوننا قد أفردنا لها مقالة مستقلة ومايهمنا في هذه المقالة المتواضعة هو توضيح مفهوم النظام الرئاسي للحكم وبيان الفرق بينه وبين الأنظمة الآخرة في البلدان الديمقراطية.من المعروف أن الديمقراطية بمعناها الحرفي هو (حكم الشعب) وهي كلمة إغريقية كان الاغارقة يستخدمونها حرفياً حين كان سكان المدينة يجتمعون دورياً لأخذ القرارات الخاصة بتلك المدينة. ثم تطور مفهوم الديمقراطية مع تطور الحياة البشرية واختفت الديمقراطية الإغريقية وظهرت بدلاً منها في القرون الوسطى الأوروبية مايسمى بالديمقراطية الدستورية وبمرور الزمن أخذت الديمقراطية (الكلاسيكية) معان مختلفة منها:*1- الديمقراطية المباشرة: والتي تعني شكلاً من أشكال الحكم يعني الحق المباشر لكل الناس لاتخاذ القرارات بأنفسهم عن طريق التصويت على كل شيء تم تثبيت رأي الأكثرية.*2- الديمقراطية التمثيلية : التي تثبت شكلاً من الحكومة التي تتخذ القرارات فيها لا من قبل السكان بل من قبل ممثليهم المنتخبين والمسؤولين أمامهم إلا ا ن هذا النوع من الديمقراطية تطور مع الزمن، وظهر مايعرف بـ: *3-الديمقراطية الدستورية: التي تقرر نوعاً من الحكومة تخضع للقيود التي يفرضها دستور الدولة الذي يثبت واجبات السكان وحقوقهم والمثال البارز للديمقراطية الدستورية هو مايجري في ولقد أدت الديمقراطية بنمطيها التمثيلي والدستوري إلى ظهور الأحزاب السياسية حيث يعمل كل حزب من اجل الحصول على المقاعد البرلمانية لكي يشكل الحكومة، (السلطة التنفيذية) بمفرده أو بالائتلاف مع الحزب الذي تختاره أو الذي يقبل التعاون معه.ونتيجة لظهور الأحزاب السياسية في بعض البلدان واتساع نفوذها في تلك البلدان أصبحت الديمقراطية تعني حق المنافسة بين الأحزاب السياسية للسيطرة على الحكومة عن طريق الحصول على الأكثرية البرلمانية لاستخدامها لإقناع الرأي العام ورئيس الدولة بذلك وأدت المنافسة الحزبية إلى ظهور القوائم الحزبية حيث تقرر قيادة الحزب قائمة المرشحين لعضوية البرلمان وتقدمها للناخبين لكي يقوموا بالتصويت عليهم لاختيار واحد منهم أو أكثر في كل منطقة أو دائرة انتخابية مرة كل 4 سنوات أو 5 سنوات.ولما كانت معظم الأحزاب في البلدان الرأسمالية ممثلة لمصالح مجموعة أو طبقة معينة من السكان، فان لها مصالحها الخاصة بها، بل المتناقضة مع مصالح الطبقات الأخرى فمثلاً قامت حكومة مرجريت تاتشر في بريطانيا وهي حكومة محافظة قامت بين عامي 1979-1990باصدار قوانين تقيد تقيد حقوق النقابات العمالية وتفسح المجال للأغنياء ليزدادوا إثراء على حساب الفقراء. ولما كان الحزب الواحد-عادة- لايستطيع لوحده الحصول على الأكثرية الضرورية لتشكيل الحكومة فانه يضطر لتشكيل تخالف مع بعض الأحزاب الأمر الذي قد يؤدي إلى تعطيل مصالح بعض الشركات الاقتصادية مما يعني أن هذا التحالف قد يحدث جواً ومعادياً لمصالح بعض الشركات الداعمة لهذا الحزب أو ذاك ولذلك تضطر بعض الأحزاب إلى الانسحاب من التحالف والاندماج في أحزاب أخرى أو البقاء في المعارضة.وللتقليل من المنافسة بين الأحزاب، وللحد من الصراع داخل قبة البرلمان تضطر بعض الأحزاب إلى الاندماج ببعضها ، فتختفي الأحزاب الصغيرة او تغيب ويكتفى بحزبين كبيرين رئيسين وهذان الحزبان الكبيران كانا قد اكتسبا قوتهما من اندماج كل منهما مع أحزاب أخرى ، لاقتراب الأهداف والبرامج الانتخابية وطرائق العمل من بعضها وفي ظل الديمقراطية أخذت بعض البلدان بمبدأ توزيع مهام الدولة بين ثلاث سلطات هي: - السلطة التشريعية (البرلمان).- السلطة التنفيذية(الحكومة).- السلطة القضائية(المحاكم).وفي ظل هذا النظام يتم التأكيد على استقلال السلطات الثلاث عن بعضها البعض غير أن هذا الاستقلال لايمكن تطبيقه عملياً لان الحزب الذي يشكل الغالبية في البرلمان هو الذي يشكل الحكومة التي تجبر أعضاءها في البرلمان على الموافقة على القوانين التي تقترحها كما تقوم أحزاب المعارضة أيضا بإجبار أعضائها على معارضة هذا القوانين والتصويت ضدها والعضو الذي يرفض الخضوع والامتثال لتوجيهات حزبه يعاقب إما بالتوبيخ أو بالفصل المؤقت أو الدائم من حزبه وبالتالي يفقد حقه في الترشيح.للانتخابات القادمة ولايندرج اسمه ضمن قائمة حزبه التي تقدم إلى الناخبين وهذا يعني أن الحكومة أي السلطة التنفيذية تفرض نفسها على البرلمان وتقر القوانين التي تريدها باستخدام أكثريتها البرلمانية وجرت العادة أن أي قانون يحصل على أكثرية الأصوات في البرلمان تقوم الحكومة بفرضه على الشعب وبالتالي تقوم السلطة القضائية (المحاكم) باستخدامه ضد المخالفين علماً أن الحكومة هي التي تعين المدعي العام وقضاة المحاكم وهي التي تدفع لهم رواتبهم بما يعني أن القضاة الذين تعفيهم الحكومة هم المخولون بتنفيذ قوانينها وبالتالي لايستطيعون الخروج عن إرادة الحكومة.والسلطة في النظم الديمقراطية تقوم على أساس تداول السلطة بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة أي أن السلطة ليست قاصرة على حسب بعينة ولذا لابد من التعددية في الحكم فالحزب الحاكم سرعان مانراه يتقهقر ويحل لمحله حزب آخر لذا فالتصارع والتنازع وليد التعددية فأينما توجد التعددية يكون الصراع قائماً لان كل حزب يسعى لتحقيق اهدافه ومبادئه أملا في الوصول إلى السلطة وتكون لدية رغبة حقيقية في الوصول إلى الحكم وإزاحة الحزب الآخر، علماً بان كل حزب سياسي لديه منهج يمثل المبادئ التي يؤمن بها أو التي يعمل من اجل نشرها والدفاع عنها.وعادة مايخضع كل حزب سياسي إلى تنظيم دقيق وحازم يحكم أعضاءه ليتمكن من التصدي لحالات الهجوم من القوى المنافسة وبالتالي يلزم الأعضاء بطاعة الأوامر التي تصدر إليهم من قياداتهم الحزبية وتنفيذ كل مايطلب منهم وصار من المتعارف عليه أن أي حزب ناجح لابد أن تكون له قيادة قادرة على توجيه الأعضاء إلى الوجهة التي تريدها وتحقيق الغاية التي يعملون من اجلها وغاية كل حزب هي الوصول إلى مركز السلطة لان السلطة هي التي تمده بالعون والمساندة لتحقيق اهدافة وبرامجه.ويمكن النظر إلى الديمقراطية في البلدان النامية ومنها بلادنا إلى ثلاثة مستويات متداخلة ومترابطة بعضها ببعض وهذه المستويات هي:المستوى الأول: النظر إلى الديمقراطية باعتبارها نظاماً للقيم وتتمثل القيم الديمقراطية في الحرية والعدالة والمشاركة والمساواة والتسامح السياسي والفكري والقبول بالتعددية السياسية والاختلاف والتداول السلمي للسلطة بالاحتكام إلى إرادة الشعب واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون .المستوى الثاني: النظر إلى الديمقراطية باعتبارها أسلوب الممارسة السلطة وتنظيم العلاقة بين الدولة والمجتمع وذلك من خلال مجموعة من الأطر القانونية والهياكل السياسية والمؤسسية والقواعد الإجرائية التي تنظم الممارسة الديمقراطية وهنا تبرز عدة عناصر تتعلق بتنظيم العلاقة بين السلطات وطبيعة النظام الحزبي والنظام الانتخابي وبينة البرلمان.المستوى الثالث: النظر إلى الديمقراطية باعتبارها نمط حياة ويتم التركيز هنا على مدى توافر قيم الممارسات الديمقراطية على صعيد مؤسسات المجتمع كالأسرة والمدرسة والجامعة والنقابة والحزب والنادي.. الخ.ومن غير شك أن الديمقراطية ليست النموذج الوحيد الذي يمكن الآخذ به في بلادنا ولكن العبرة تكمن في مدى قدرتنا من الاقتراب من الممارسة الديمقراطية .. ففي بلادنا هناك مؤسسات وهياكل وإجراءات تأخذ من الديمقراطية شكلها دون مضمونها مما يجعلها مجرد ديكور الديمقراطية زائفة وهذه الحالة لاتقل خطورة عن حالة غياب الديمقراطية فهناك على سبيل المثال عدد من الدول الأسيوية قد حققت قفزات تنموية في ظل نظم تسلطية قبل أن تنتقل إلى الأخذ بالديمقراطية كما إن النظم الديمقراطية قد لاتكون دائماً مصحوبة بالاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي بل قد تكون مصحوبة بالعديد من الاضطرابات التي تؤدي إلى عدم الاستقرار ولكن تبقى الديمقراطية –مع ذلك- أفضل صيغة سياسية عرفتها البشرية في العصر الحديث لممارسة السلطة وإدارة شؤون المجتمع وتنظيم علاقة الشعب بالدولة.كما إن الديمقراطية هي أفضل نظام سياسي يمكن أن يوفر ضمانات احترام حقوق الإنسان فمن خلالها يمتلك الشعب آليات التصحيح والمراجعة من خلال إتاحة الفرصة للشعب لتغيير حكامه بصفة دورية عن طريق انتخابات حرة ونزيهة كما أن الديمقراطية يمكن أن تشكل حالياً انسب الأطر السياسية التي يمكن في ضوئها بلورة حلول لمعظم المشكلات التي تعاني منها بلادنا.وليس بخاف أن للديمقراطية مشكلات كما هو الحال في بلادنا التي صارت في ظل الديمقراطية تعاني من مشكلات كثيرة تولدت عن الحراك الاجتماعي وأضحت تواجه تحديات عديدة التي من شانها أن تؤدي إلى حدوث ردة عن الديمقراطية ولاشك أن علاج المشكلات الناجمة عن الممارسة الديمقراطية يتمثل في إعطاء المزيد من الديمقراطية وتوفيره الضمانات اللازمة لسلامة تطبيقها وفقاً لقواعدها المتعارف عليها.وعلى الرغم من أن عمر الديمقراطية في بلادنا ليس طويلاً إلا أن شعبنا قد اكتسب بعض التجارب في ممارسة تطبيقها، وهذا لايعني إنها قد ترسخت واصحبت أمرا مفروغاً منها.وقد شهدت سنوات مابعد الوحدة المباركة وقيام الجمهورية اليمنية عام 1990م نمواً ملحوظاً في دور الأحزاب والتنظيمات السياسية ومايعرف بمنظمات المجتمع المدني والهيئات الشعبية غير الحكومية ولكن التجربة اليمنية في هذا المجال لاتزال قصيرة على سبيل المثال ظهرت العديد من التشريعات والقوانين التي تحد من انتهاك الحقوق الإنسانية إلا أن ذلك لايعني أن الحكومة اليمنية صارت غير قادرة على انتهاك هذه الحقوق إذ لازالت هذه القدرة موجودة وعلى نطاق واسع في كثير من الحالات ولكن قدرة الحكومة على إخفاء هذه الممارسات تتقلص باستمرار لأنها أصحبت في ظل الديمقراطية تتعرض لضغوط داخلية وخارجية تطالبها للإقلاع عن هذه الانتهاكات وتحسين سجل حقوق الإنسان.ولقد ساهمت بعض المتغيرات الدولية الجديدة في خلق بيئة ملائمة للسير نحو الديمقراطية ومن تجليات ذلك صارت بلادنا ترفع شعارات الديمقراطية والتعددية الفكرية والسياسية وحقوق الإنسان. والمواكبة هذه الشعارات قطعت بلادنا شوطاً لا بأس به في طريق الانتقال من السلطوية إلى الديمقراطية والتعددية السياسية إلا أن التعددية السياسية مازالت في مرحلة التجريب ولم تنضج بعد وهو مامن شانه أن يؤثر سلباً على العملية السياسية برمتها ويعرقل طريق المسار الديمقراطي.ويمكن القول إن التعددية السياسية في بلادنا تسير في طريق متعرج لعدة أسباب أبرزها:*1-إن الحزب الحاكم- المؤتمر الشعبي العام- هو حزب الرئيس فهو لذلك يكتسب قوة في الانتخابات مستمدة من قوة الرئيس وسلطته لامن قوته الذاتية فهو أن تغلب في الانتخابات على الأحزاب الأخرى وحصل على الأغلبية في البرلمان في الوقت الراهن فليس ذلك ثابتاً ولا حتمياً إذ من الممكن أن يخسر في أية انتخابات قادمة بما من شأنه أن يسقط حقه في تشكيل الحكومة إلا بتحالفه مع أحزاب أخرى.*2-معظم الناخبين في بلادنا غير متعلمين أن لم يكونوا أميين وهذا من شأنه أن يجعل العملية الانتخابية غير قادة على اختيار المرشحين الفاعلين ولا التمييز بين من هم أكثر مهارة وأفضل تعليما وارتباطاً بقضاياهم وهمومهم وبين غيرهم ممن يفتقرون إلى العلم والمعرفة والدراسة والفكر وذلك فان الناخب لايختار شخصاً بعينه لعدم معرفته به بل يقترع للرمز الانتخابي الذي حل محل الاسم وهذا من شأنه أن يدفع لاختيار أشخاص لايهتمون بالاحتياجات العامة للشعب.*3- لجوء بعض الأحزاب إلى استخدام عوامل مؤثرة في الناخبين كتقديم التزامات وتعهدات وإغراءات يصعب تحقيقها في الواقع وربما تلجأ إلى الشخصانية باختيارها شخصية من قبيلة معروفة لاجتذاب أصوات الناخبين فيها بصرف النظر عن قدرات تلك الشخصية ومهاراتها.*4- تحاول بعض الأحزاب للدفاع عن شرعيتها التبشير بحماية الأفراد وممتلكاتهم والعمل على تنفيذ العدالة بين الأفراد بالتساوي ولكن الحقائق تؤكد عكس ذلك فضمان الحرية الفردية قد يتعارض مع مصالح آخرين فمصالح النخب ربما تتعارض مع مصالح الفرد العادي الذي يبحث عن فرصته في العمل وحقه في التعليم والرعاية الصحية ففي واقعنا الاجتماعي هناك الشخص العاطل عن العمل الذي ينام في الرصيف، كما أن هناك الشخص المهدد بالبطالة جنباً إلى جنب مع النخب الصغيرة المتميزة من كبار موظفي الدولة وكبار أصحاب الأعمال وكبار القادة العسكريين وكبار مشائخ القبائل ... الخ فهؤلاء يما يمتلكون من مال ومالديهم من نفوذ توجيه الناخبين مما يحول دون وصول أكفأ العناصر وأخلصها إلى البرلمان مما يجعل البرلمان فاشلاً بل عاجزاً عن حماية حقوق الفئات الضعيفة اقتصادياً وهم الأكثرية في مثل هذا الواقع يعلن الشخص(أ) فشله في المنافسة الاقتصادية وهو مايؤدي إلى إفلاسه السياسي أيضا فيرفض الإدلاء بصوته في الانتخابات التي يتحمس لها ويديرها الشخص(ب) المرفه.*5- في خضم الصراع القائم بين الأحزاب السياسية تجمع الدولة ماليتها ومصروفاتها من أموال الضرائب والجمارك وغيرها، وهو مايؤدي إلى زيادة الصراع حيث تناضل الفئة الضعيفة اقتصادياً ضد هيمنة النخب القوية اقتصادياً ولهذا يعلن الشخص(ب)عن فشله في المنافسة الاقتصادية وبالتالي عن إفلاسه السياسي في اغلب الحالات وفي هذه الحالة يرفض الإدلاء بصوته في الانتخابات للشخص (أ) المرفه أو العكس.*6- وفي خضم هذا الصراع أيضا تعمل الدولة عادة لصالح النخب التي تدفع الضرائب وتمول الحملات الانتخابية للمرشح الذي يؤيد النخب أو تلتقي معها في المصالح ويكون ذلك على حساب مصالح الفقراء والضعفاء.*7- في كثير من الحالات تؤدي المنافسة بين النخب المرفهة إلى التصادم وتعارض المصالح فيما بينها وقد يؤدي هذا التعارض إلى التصادم المسلح وهو مايدخل البلاد في دوامة من عدم الاستقرار.*8- غالباً ماتكون العلاقة بين السلطتين التشريعية (البرلمان) والسلطة التنفيذية (الحكومة) تنتابها بعض الحساسيات والتعارضات خصوصاً عندما تكون الحكومة مشكلة من عدة أحزاب فعادة مايحصل بعض الإخلال في ميزان القوى لهذا الطرف أو ذاك مما يؤدي إلى فشل الحكومة أو عجزها عن تحقيق أهدافها خاصة في الدول حديثة العهد بالتجربة الديمقراطية كبلادنا.*9- في الحالات التي تتشكل فيها الحكومة من حزب الأغلبية أي حزب السلطة فان الحكومة عندئذ تكون في وضع يمكنها من توجيه البرلمان وفرض سلطتها عليه بل ربما التحدث باسمه والعمل نيابة عنه وهو ما يفقد البرلمان دوره الرقابي خاصة إذا كانت الحكومة مشكلة كلها أو بعضها من أعضاء البرلمان.*10- تستطيع حكومة الأغلبية في كثير من الحالات أن تستغل المناصب وتضغط على أعضاء البرلمان لتمرير كثير من القضايا التي ربما اعترضوا عليها وبإمكانها في الوقت نفسه بما لديها من سلطة أن تؤثر في نتائج الانتخابات بحيث تضمن نجاح المرشحين الذين تريدهم وهو مايحول دون التداول السلمي للسلطة.*11-في ظل المنافسة الحزبية يستطيع حزب الأغلبية أن يختار رئيس الدولة في النظام الجمهوري وربما يعقد صفقات وتحالفات مع أحزاب أخرى لإنجاح مرشحة للرئاسة وفي بعض الحالات لاتقبل الأحزاب المتحالفة مرشح حزب الأغلبية فتنظم إلى المعارضة فتصوت ضد رغبة الحزب الحاكم فتدخل البلد في دوامة من الصراع السياسي ربما تؤدي إلى فراغ دستوري بسبب عدم الاتفاق على مرشح للرئاسة قد ينجم عنها أزمة سياسية ربما تؤدي إلى حرب أهلية إذا ما غذيت من الخارج كما هو حاصل في لبنان.*12- في الحالات التي يكون الحزب الحاكم ضعيفاً برلمانياً، بحيث لايستطيع تمرير مشروعاته وقوانينه على البرلمان فحينئذ لاتستطيع السلطة التنفيذية (الحكومة) الحد من سلطة البرلمان مما يضطرها إلى حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة وبالتالي يختل التوازن وينعدم الاستقرار خاصة إذا كانت السلطة التنفيذية لاتستند إلى قاعدة جماهيرية.واستناداً إلى ماسبق ذكره فان النظام البرلماني القائم على التعددية السياسية كثيراً مايتعرض لاضطرابات واهتزازات تؤدي في كثير من الحالات إلى تجميد نشاط البرلمان أو إلغائه والدعوة لانتخابات جديدة وبالذات في أوقات الأزمات ومن هنا فان بعض الدول لاتميل إلى النظام البرلماني طالما يكون سبباً في إضعاف الحكومة والتقليل من هيبتها وفي هذه الحالة تبرز المطالبة بنظام رئاسي كامل.ومن خصائص النظام الرئاسي الكامل انه يتطلب وجود رئيس منتخب من قبل الشعب بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بحيث يجمع في شخصية صفة رئيس الدولة ورئيس الحكومة فهو الذي يختار الوزراء والقضاة وكبار القادة العسكريين والآمنين دون تدخل من السلطات الأخرى، فيكونون جميعهم مسئولين أمامه فقط وفي هذه الحالة يكون رئيس الدولة في وضع يسمح له بمحاسبة أعضاء الحكومة لأنه هو الذي اختارهم ويكون في الوقت نفسه في مركز أقوى من البرلمان لأنه منتخب من الشعب باجمعه في حين ان عضو البرلمان منتخب من دائرة انتخابية معينة وان الغالبية التي يتمتع فيها محصورة في نطاق دائرته وفي هذه الحالة يكتسب الرئيس قوة كبيرة ويتمتع بنفوذ واسع يمكنه من التحكم بمقاليد الأمور والإمساك بمفاصل السلطة لأنه هو نفسه سيكون رئيس الحكومة وفي هذه الحالة فان الحكومة ستسمد قوتها من قوة الرئيس إن كان قوياً وستضعف بضعفه إن كان ضعيفاً وفي الحالتين يبقى الرئيس هو المسؤول مسؤولية كاملة عن نجاح الحكومة أو إخفاقاتها.ولست ادري هل هذا النظام يناسب بلادنا في المرحلة الراهنة أم لا؟ وهل هو قادر على إخراج البلاد من أزماتها المتعاقبة؟ علماً أن مبادرة الرئيس تؤكد بما لايقبل الشك أن النظام السائد حالياً يواجه كثيراً من الصعوبات والمعوقات بسبب عدم استيعاب القوى السياسية في بلادنا لمعطيات المرحلة الراهنة وتحدياتها المستقبلية فإذا كان النظام السائد حالياً يعطي للحزب الحائز على الأغلبية في البرلمان حق تشكيل الحكومة بمفردة او بالتحالف مع أحزاب أخرى، في حين يعطي لرئيس الدولة حق تعيين رئيس الحكومة، فكيف سيكون الحال إذا ماكان حزب الأغلبية من الأحزاب التي لايرتاح لها الرئيس أو هي لا ترتاح له؟ إلا نتوقع حصول إشكالية في هذه الحالة؟ولتلافي هذه الإشكالية فان الحاجة تقتضي توافر درجة عالية من المرونة الحزبية وتوازناً بين القوى وهو مايستوجب وجود غرفتين للسلطة التشريعية لاسلطة واحدة أحداهم مجلس النواب والأخرى مجلس الشورى.فإذا كان مجلس النواب بوضعه الحالي يتشكل من ممثلين للدوائر الانتخابية البالغ عددها 301 دائرة، فان هناك اختلالاً في تمثيل المحافظات حيث تحصل بعض المحافظات على مقاعد في البرلمان أكثر من محافظات أخرى، فان هذا الاختلال ربما يؤثر سلباً على بعض القرارات الإستراتيجية مما يستوجب وجود مجلس آخر وهو مجلس الشورى الذي يتطلب تشكيلة تساوي المحافظات في نسب التمثيل بما يسمح بايجاد نوع من التوازن بين مصالح سكان جميع المحافظات دون استثناء.وإذا ما أريد التصويت على أي من القضايا أو القوانين الإستراتيجية فلابد في هذه الحالة من اجتماع المجلسين بحيث يكون التصويت متوازناً وغير خاضع لضغوطات حزبية أو إيديولوجية وفي هذه الحالة فان النظام الرئاسي يكون ملائماً لكونه فوق الأحزاب، فهو سيكون بمثابة صمام أمان للوحدة الوطنية وعاملاً من عوامل الاستقرار السياسي وتفعيل عمل الحكومة ذلك ان الرئيس في النظام الرئاسي الكامل باعتباره منتخباً من الأمة فانه بالضرورة سيكون في حل من التزاماته لحزبه أو منطقته لان الشعب باجمعه هو الذي انتخبه وهذا يعفيه من الولاءات الضيقة إذ يستطيع الرئيس المنتخب ان يلعب دوراً بارزاً في تعزيز الوحدة الوطنية وعندئذ سيصبح رمزاً من رموز الوطن ولكي يكون ذلك ممكنا لابد من القيام بجملة من الإجراءات الجريئة للتخلص من الفاسدين وإجراء التعديلات الدستورية التي تمكنه من إيجاد سلطة تنفيذية قوية برئاسته تساعده على تخطي الحواجز البيروقراطية والعمل بديناميكية عالية.