انزواء العقل العربي في دوائر الانغلاق الذاتي
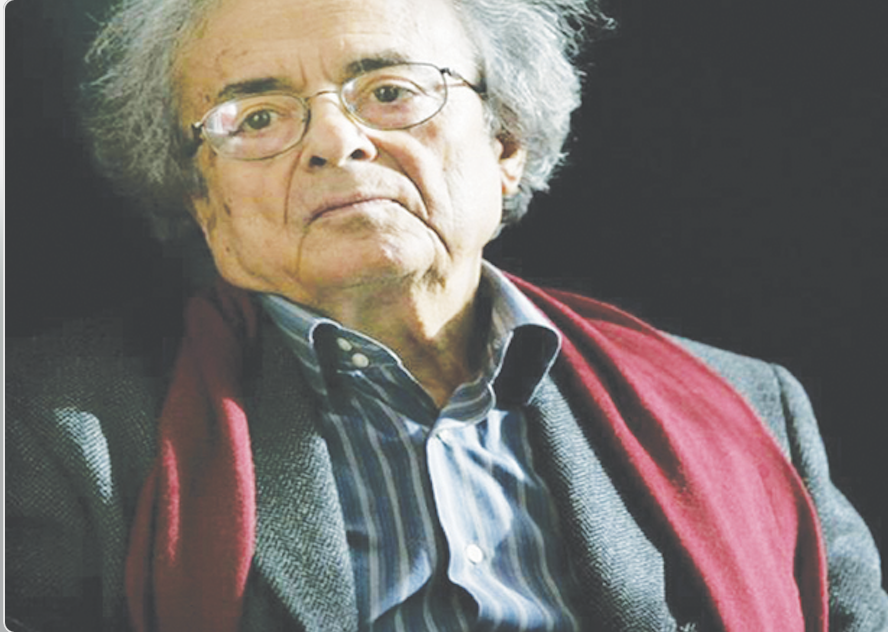
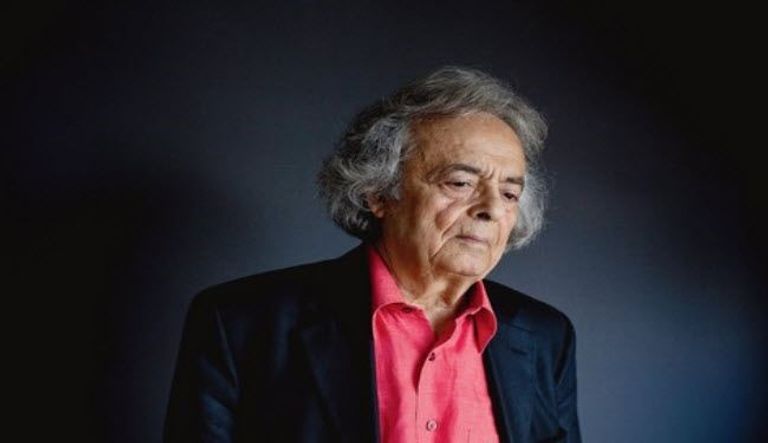
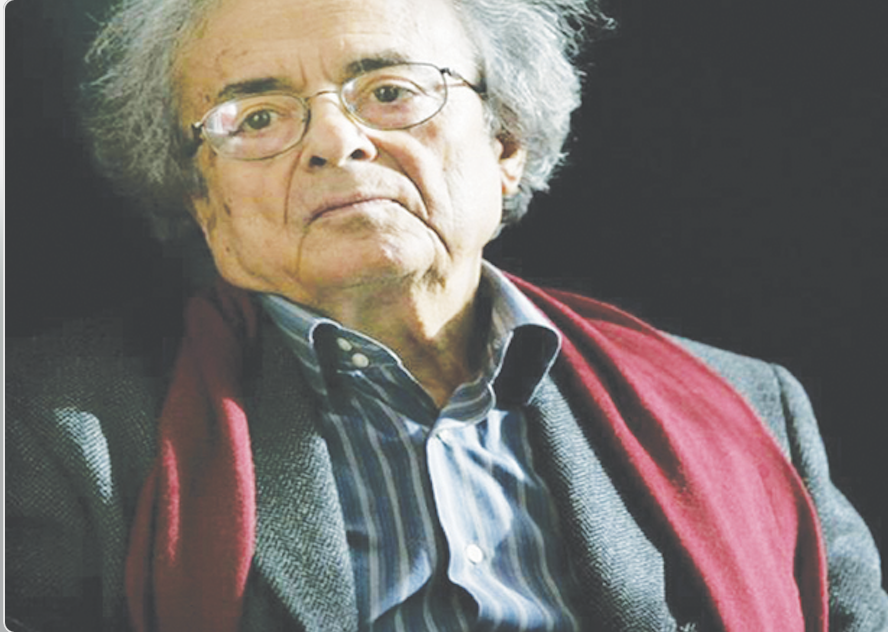
14 كتوبر / خاص :
نجمي عبدالمجيد:
في راهن الواقع الثقافي والحضاري للعقل العربي، والذي اصبح يعاني من تجاذبات حروب أهلية وفرق متصارعة في كيان الأمة، غابت عدة قضايا ومسائل عن امكانية المعالجة. بل دخلت في عمق التناحر الاجتماعي وتحول الحوار إلى مصادمات، وطرح الرأي انفجارات لقبائل ثقافية، وتشظت الفضاءات المعرفية إلى دويلات لها نزعة الذاتية وهوية الاغتيال، وصنع جماعات الارهاب للعقول وحرية الفكر والوعي وجعله متهماً لا وضع له في جغرافية الوطن بل هو ما بين القتل أو المنفى.
في هذا التصاعد الذي لا يقود إلا إلى مزيد من سحق وعي الأمة بتاريخها وتراثها، ومكانة المثقف في قراءة المشهد تأتي اطروحات ادونيس كي تخلق السؤال من عمق الأفق الأبعد عن مساحات الحرائق في ذاتية الوضع العربي.
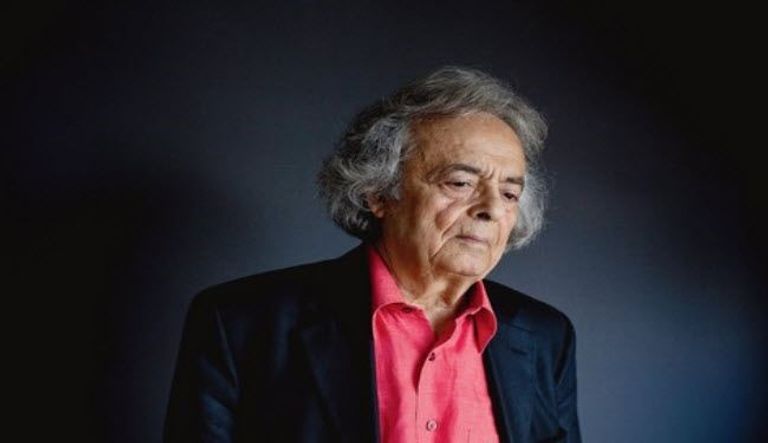
- أزمة العقل العربي تسكن في أبعاد مكوناته الحضارية فهو لا يرى من الحضارة إلا بعضاً من صورها عند الزوايا المظلمة
- رفض الآخر وإن كان من نفس الانتماء خلق كل مسافات التقاطع بين وعي الذاكرة وحركة التاريخ
- حالة قراءة النص عند العقل العربي مازالت بعيدة عن طرح التساؤلات دائمة الهروب إلى منافي الإجابات المحنطة
ما هو موقفنا من التراث الماضي كجزء من الهوية؟
كيف نكون في اطار هذه المفارقات نوعية من الصلة مع هذا التاريخ؟
ادونيس لا يذهب هروباً نحو الاجابة المنقذة من مأزق صنع صفات الهوية حسب آلية الصراع في واقع العقل العربي.
الثقافة العربية ـ الإسلامية ليست كل مفاصلها هي طوق نجاة لحماية الذات.
هنا ندرك ان وضع الماضي في صورة الكمال الأعلى هو من أسقط نزعة الخروج والتحرر من مرض الانفراد والتميز عن الآخر، بل الوصول إلى منزلة ان لا اتصال مع حضارة الراهن بل الاكتمال في الانطواء وكأن المغاير هو الابادة والمحو للهوية، انها عملية تصنيع للذات النقية الخالية من كل النواقص.
وهو ما جعل إعادة وفرض إلباس الحاضر ثوب السابق بكل ما فيه من بصمات الجرائم والتزوير والغدر وعقيدة العنف والدم كي نقول للآخر: في ذاتنا الكامل كله، وما جاء من الخارج لا يقدم لنا إلا شبح التسلط والفناء.
ادونيس ينفي هذا النوع من عمليات القطع التاريخي والحضاري مع العالم؛ لأن التراث العربي ـ الاسلامي لم يكن وليداً لمرايا البعد الواحد في حضارتنا بل كان الاسلام حضارة وتاريخاً في قلب العالم.
وهذا ما فتح أبواب الطرح والمطالبة ومد جسور الوعي ليكون الجوهر تجاوز جمود الفكر المنطقي بل فتح العقل المعرفي في التاريخ الاسلامي أبعد المسافات في لقاء الحضارات.
طرح ادونيس العديد من تساؤلات نقد الفكر والثقافة والتاريخ وصلة كل هذا التراث واشكال اسقاط هذا الارث على مفهوم الأمة له.
هنا نحاول خلق بعض من تجاور المطالبات التي ترى في واقع الأزمة ذهاباً نحو مزيد من التشرذم والهدم.
لعل مأزق صراعات وفوضى الراهن ما هي إلا انعكاس لغياب وعي التراث وقراءة النص المحصور في دائرة قهر المقدس وتحويل النصوص التاريخية إلى فرق اغتيالات تطارد كل محاولة للخروج عن عقلية الكهوف المظلمة.
ان المجتمع العربي ـ الاسلامي مازال يقف عند حدود الخوف والهروب من مواجهة الحقائق الصادمة.
الحرية والفكر والثقافة والمقدس والسياسة وغيرها من محاور الوجود الانساني مازالت عند مسافات الرعب والرعشة والرهبة والابتعاد عن كشف دورها في البناء والهدم في الاداراك.
الهروب لا يعطي جواباً ولا يصنع معجزة الحل، بل يقود إلى تراكمات في الأوجاع والتدمير وكسر الطموح. بل صناعة مجتمع الجمود عند مدركات من انتاج السابق الذي يصبح طوقاً من جدران الصمت العازلة عن نبض الحياة. ذلك السكون الجاعل من ملاذ الاستسلام هوية دائمة الحضور في بحيرة الرماد في وعي الذاكرة.
الوقوف أمام هذه القراءات من وجهة نظر ادونيس لا تعني طرح الرد القاطع لهذا المنتج من ثقافة الرفض والصدام في الفكر العربي.
بل هي محاولة للاسهام في هدم تلك الحواجز الجامدة بين التاريخ والراهن.
وكيف يكون في كل هذا؟ المثقف هو ضمير الأمة. وهل هذا الضمير هو ضمير المهادنة والتلاعب حسب جبروت السلطة القهرية؟
ام هو ارادة التحدي والمواجهة ضد كل هذا التدمير والسحق لمعنى وجود الانسان؟
مما يطرحه ادونيس في هذا المحور قائلاً: (التاريخ العربي حافل بالثورات فهي لم تهدأ قط في يوم من الأيام انها ثورات صغيرة بالتأكيد أو ثورات كان هدفها تقديم تأويل مغاير للاسلام ولكن جميع الرجال النابغين من العرب في التاريخ الاسلامي من ابي نواس حتى المعري وجميع الشعراء العظام والفلاسفة شقوا عصا الطاعة على الدين.
وما من فكرة من الافكار صدرت مباشرة عن الدين مثلما يمكن لرائحة زكية ان تصدر عن زهرة. فالمفكرون والشعراء خلقوا زهوراً اخرى كي يستخلصوا منها رائحة زكية اخرى لهذا لم يكن هناك أدب ديني في الاسلام، من جهة كونه ديناً بحصر المعنى. وفي السياق ذاته لم تكن هناك فلسفة أيضاً كان هناك لاهوت وشريعة ، أعني ما تمحور حول تفسير القرآن وسن القوانين والقواعد، وخارج نطاق ذلك كان الأدب والشعر كثيراً ما يستخدمان لمناوأة الدين. فكل شاعر كان يعتبر نفسه نبياً.
اليوم اصبحت الثورات مختلفة. فالتيار المهيمن صار همه دائماً ان يثبت ان هناك ثورات ترفع راية الاسلام، ولكن في واقع الحال مثلما أرى، ثورات سياسية ليس لها اتساع آفاق الثورات الشاملة، الايديولوجية، والفلسفة، والفنية، على غرار الثورات التي هي مدار اهتمامنا وحديثنا.
فالثورات اليوم تنحصر بمطالب سياسية في مواجهة السلطة القائمة أو في مواجهة هيمنة خارجية لهذا فهي ليست ثورات حقيقية).
ما بين إرث الماضي من ثورات وتمرد وهدم وحتى اليوم مازالت الأزمات في الذات تعاني من نواقص ما كسبت من أزمنة الفوضى والصدام في تاريخ الحضارة الاسلامية.
هنا نعود إلى طرح ابن خلدون في حالة العقل العربي المحصور في دائرة مغلقة وعجزه عن صناعة المغاير.
وفي هذا يرى ادونيس ان الثورة هنا لا تعني غير الوصول إلى الحكم.
هذا ليس وليد الحاضر بل في تكوين الذاكرة العربية ـ الاسلامية له مراكز النفوذ إلى حد الهدم الكامل لركائز المجتمع والتي هي تعاني من فقر في خلق الرؤية الذاهبة نحو الخروج من مأزق التاريخ.
عند مفترق طرق الازمات، كيف يرى المثقف وضعه في كل هذا؟؟
عن ازدواجية الواقع العربي يقول ادونيس: ( أنا أرى أن لكل مجتمع من المجتمعات مستويين اثنين.
احدهما ظاهر والآخر محتجب، سري. والمجتمع المحتجب هو في اعتقادي ذلك الذي يعيش بأقصى قدر من الحرية. غير أن هذا الطابع السري مكبوت وغير معترف به بل إنه يتعرض لسهام النقد من قبل المجتمع الظاهر، المسيطر مجتمع القوانين والسلطة والمال. ها هنا أيضاً يصعب عليك أن تطرحي أحكاماً، فأنت لا تستطيعين أن تجري مقارنة بين مجتمع وآخر.
هذا صعب. فلكل مجتمع آلية عمله، وطريقة وجوده. تجري غالباً المقارنة بين دمشق وبيروت، على سبيل المثال ففي دمشق مجتمع خفي يعز على التصور، أشد كثافة من المجتمع السري في بيروت، على الرغم من أن بيروت تبدو في الظاهر أكثر تحرراً).
هنا في عمق ذاتية المجتمع العربي نجد هذا الانقسام ما بين الباطن والظاهر.
التناقض ما بين ما نرى، وما يسكن في الزوايا الخلفية، وهو ما ينتج عدة صور وأشكال لواقع الإنسان العربي، بمعنى أن لنا حياة تظهر للخارج، تدعي ما ليس لها من حقائق وهي أكاذيب تسوق وكأنها الحدود الواقعة عند مكونات الهوية، وهي حالات الخديعة التي قد تذهب بهذا المجتمع نحو الصدام والحرب، إن سعى من يكشف حقيقة هذا الزيف.
ومجتمع يسكن في المسافات القصية، وهي تعد منطلقاً لرد فعل الفرض القسري على الوعي والفعل.
هذا ما يطرحه علينا أدونيس، في واقع الهزيمة في الذات العربية.
وفي محور هذا التناقض بين الظاهر والباطن في الحياة والثقافة العربية يضيف قائلاً: (مثلما قلت سابقاً، فإن هذا النوع من المجتمعات التي يحددها فقدانها للحرية يخلق مستويين اثنين على الصعيد الثقافي: مستوى مرئياً يتوافق مع غالبية المؤمنين، كما يتوافق مع النظام السياسي، ومستوى آخر غير مرئي، محتجباً. وهذا الجزء المحتجب هو الذي يفضله أولئك الذين يرغبون في ان يعيشوا بحرية. من المؤكد أن هذا نوع من النفاق، ومن الازدواجية).
في مجتمعات يسيطر عليها حكم الجهل والعنف تكون قضايا التعليم والثقافة قليلة الأهمية والمكانة بين العامة. هذا النوع من الحالات تصبح فيه مسائل الوعي في أدنى درجاته عند العامة، لذلك لا يصبح النصيب، إلا لمن يملك قوة السلاح، وهو من يصل إلى المال والسلطة.
هذا النوع من الانحياز، في قوة الدفع في المجتمع، يخلق تراكمات من الجهل والفوضى، ويصبح الطريق نحو القادم لا يكون إلا عبر الصراعات الدامية وانهيار كل وسائل التقدم، وتوسع الفساد والسقوط الأخلاقي وتحول معظم العامة إلى جماعات إجرامية تهدد وتهد الحياة من داخلها.
هذه حالات تعاني منها اليوم عدة دول حيث خرجت من وعي المجتمع المدني، إلى عقيدة الإرهاب والعنف. وأصبح الجاهل هو القائد والزعيم، أما المثقف المتعلم فلم يعد له من دور فاعل في المجتمع، وربما يتحول إلى عنصر مخالف، بما في عقله من ثقافة المجتمع المدني، إلى قوة تزرع التشرذم والعنف وهنا تدخل ثقافة السيطرة النفسية التي تعمل على غسل أدمغة الجماهير، وتفرض عليها رؤية أن الواقع لن يتغير إلا عبر لغة السلاح ومسارات الدم. بل هدم كل قوانين المجتمع المدني.
هنا يصبح قانون العنف هو المفروض بل هو السيادة القانونية. وهو ما حذر منه ادونيس في كتابات عدة سعت لطرح لغة الحوار المدرك بدلاً من وسائل الإرهاب والتطرف التي ذهبت بالحياة وإنتاج التدمير.
وفي نقطة أخرى يقول أدونيس: (الكتابة. أكرر لك: إذا لم أكتب فأنا أشعر بأنني غير موجود، بالكتابة اكتشف من أكون، أتعود اكتشاف ذاتي والإفصاح عنها... تتيح لي الكتابة أيضاً معرفة الآخر. ومعرفة العالم بالتأكيد. يراودني إحساس بأن الحياة بأكملها حركة اكتشاف متواصلة. وهذه الحركة تتيح للإنسان أن يشعر بأنه موجود، وأنه يساهم في خلق العالم وفي تغييره... وما يمكن ان يقال عن الشعر يمكن أن يقال عن جميع أشكال الخلق، والفن، والفلسفة، إلخ).
هناك مقولة للكاتب والأديب الفرنسي البير كامي هي: هناك شمس لا تغيب في قلب ما أكتب.
لا يرى فكر وإبداع أدونيس في نوعية العلاقة بين الكتابة والوجود مجرد اتصال فكري عبر الذات والوجود.
فكل فنون الإبداع الإنساني، تسعى للخروج من حصار ذلك السابق إلى ماهو مغاير.
من يقرأ أعمال أدونيس الكثيرة في الشعر والنثر، يرى ظاهرة الرفض والتمرد ضد ما يقهر وعي الفرد بل الأمة. هنا التاريخ لا يقاوم كحضارة واعية من خلال إعادة سرد الماضي. ولكن من خلال صياغة هوية العصر.
أدونيس لا يرى في فعل خلق الكلمة، إلا عبر كسر هذا الحاجز الواقع بين العقل والتساؤل.
الماضي طالما هو المتسيد على الراهن، لم يكن فيه إلا أزمة بل بؤرة صدام وصراع حتى يظل في دائرة الاستحواذ على عقل ونفسية الفرد.
هنا تصبح مسارات الحضارة عاجزة عن إنتاج أهداف الرؤية، التقدم.
الوعي في قبضة هذا الانزواء لا يتجاوز حدود الموضوعية الذاتية.
العالم هنا هو أسير نص تراثي، كانت له خصائص وماديات أسباب وجوده.
بينما في الراهن تكون تلك العوامل قد نفيت عن الواقع، بل بعض منها قد جرفته رياح الانحراف وأفكار المصالح ولعبة الأهواء.
أدونيس يرى في الكتابة تأسيساً لعالم مغاير، لابد للوعي أن يخرج من الطاعة العمياء لنص التراث، لابد من نزع قشرة الأمس كي نرى جوهر العمق.
الميلاد في الكتابة، صناعة كيان إنساني في المقدرة على التفكير. فعل الكتابة هو ترسيم لصور ربما لا يقبل بها عقل قداسة الماضي، لأنها تضرب هذه الأوثان الوهمية التي نصبت في وعي التاريخ، باسم نصوص الثابت المطلق، وكأنها أبواب مغلقة لا تفتح إلا بمفاتيح الوهم الغافل عن هزات الحقائق.
الكتابة هي كائن وجودي، عنصر مادي، لكنها لا تأتي إلا عبر عقلية أدركت المسافة التي تفصل الفكر عن الواقع.
المرجع
نينار اسبر
أحاديث مع والدي أدونيس
ترجمة: حسن عودة
صادر عن دار الساقي - الطبعة العربية، بيروت.
الطبعة الأولى: 2010م.

